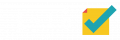حوار – عامر بن عبدالله الأنصاري
– ثلاث سنوات لإنتاج فيلم “الأساس الخالد” عن متحف عمان عبر الزمان.
– يصعب عليّ أن أغلق فكرة “ولد البلد” بإجابة صريحة توقف اجتهاد المتلقي.
– عندما كان “الرقيب” يضغط على بعض الأعمال كنا نلجأ إلى “التغريب”.
– المشهد الثقافي بعيد عن الوسط الفني رغم أنه بالأساس وسط واحد.
– العمل الكرتوني “يوم بيوم” جمع حوالي 25 كاتبا مثقفا في ورشة عمل لإعداد النص.
– أخطط أن أقتحم هذا العالم السحري، عالم السينما.
الفنان مالك المسلماني متنوعٌ في إنتاجه الفني على مدى سنوات عطائه، لتكون في رصيده أعمالا درامية تلفزيونية وأعمالا مسرحية متنوعة، قدم نفسه فيها أحيانا ممثلا، وأحيانا كاتبا، وأحيانا مخرجا، وفي أحيان أخرى كاتبا ومخرجا معًا، ومن أواخر ما قدمه، عبر مؤسسة “أكاسيا” للإنتاج الفني، الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي وثق مسيرة عمل إنشاء “متحف عمان عبر الزمان”.
ومن أواخر أعماله المسرحية “مسرحية ولد البلد” الذي كسب فيها الرهان بجمع نخبة من نجوم الصف الأول بسلطنة عمان ودمجهم مع الأجيال الفنية اللاحقة، رغم ما تكبده المسلماني من خسائر إلا أنه وكما قال: “كانت تجربة ولد البلد إيجابية، فقد خدمتنا هذه التجربة، خدمت جميع من عمل”.
وعن “الأساس الخالد”، و “ولد البلد” وأمور أخرى عديدة حدثنا المسلماني في هذا الحوار، مجاوبًا على أسئلة “عمان” برحابة صدر وبشاشة وعفوية على خلفية رائحة البن ورشفات “البلاك كوفي” وأصوات مكائن طحن القهوة وأبخرة إعدادها، فإلى ما جاء:
التجربة الأخيرة في الإخراج، الفيلم الوثائقي لمتحف عمان عبر الزمان “الأساس الخالد”، متى بدأت الفكرة ومتى انتهت؟
– الفكرة انطلقت من فريق العمل الرئيسي القائم على تنفيذ مشروع “متحف عمان عبر الزمان”، كان ذلك بعد عامين من بداية التنفيذ الفعلي للمشروع الذي استغرق حوالي 5 سنوات، الفكرة كانت إنتاج فيلم يروي قصة بناء هذا الصرح المعماري الضخم، في البداية كانت هناك آلات تصوير بتقنية “التايم لابس”، وكان الهدف الأساسي منها متابعة المشروع عن بُعد حيث كان مكتب المشروع في “غلا” والتنفيذ في ولاية منح، فتم استغلال “التايم لابس” في إنتاج الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي حكى قصة متحف عمان عبر الزمان والكثير من التفاصيل المبهرة، وهذه كانت التجربة الأولى لإدارة المنشآت السلطانية بتوثيق مشاريعها.
عملنا على إنتاج الفيلم في السنوات الثلاث الأخيرة من عملية البناء وتسوية الأرض، وحقيقة التعاون كان مثمرا مع فريق العمل الرئيسي للمشروع والفريق الإعلامي؛ لذلك احتوى الفيلم على مشاهد سُجلت من قِبَلِنا “شركة أكاسيا”، وكذلك مواد أرشيفية وثقها الفريق الإعلامي التابع لمشروع متحف عمان عبر الزمان.
أما من ناحية السيناريو فقد تطلب عملية بحث طويلة، عدد الجهات المشاركة في المشروع كبير جدا، لذلك كان سؤالنا كيف نوجد مادة فيلمية محكمة وقيّمة في مدة إجمالية ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، فحرصنا أن يتضمن الفيلم كل ما هو مميز واستثنائي بالمشروع، دون ذكر البديهيات التي تشترك فيها كافة المشروعات أو المهام الاعتيادية في البناء الخالية من الدهشة.
في البداية أخذنا كل ما نستطيع أخذه من المعلومات، من الاستشاري، والمتخصصين، ومصادر المقتنيات، والتقنيات المستخدمة، وفكرة التصميم، ومواد حفظ المقتنيات، وغيرها الكثير والكثير من المعلومات، قابلت شخصيا أكثر من 40 من المعنيين في المشروع، المادة المجموعة بشكل مبدئي كانت بحوالي 11 ساعة، ولكننا وجدنا أن الكثير من المعلومات تتشابه مع مشروعات أخرى، لذلك كان التركيز على ما هو مختلف ومميز، لضمان أن يكون هناك إيقاع متماسك للفيلم يجذب المتلقي طيلة مدة عرضه.
لديك تجارب إخراجية في الدراما والمسرح، كيف تختلف الأفلام الوثائقية، عن الإنتاج الدرامي والمسرحي؟
– الفيلم الوثائقي هو جنس فني مختلف عن الدراما، وحين أقول الدراما أعني الإنتاج التلفزيوني والمسرحي والسينمائي، الإنتاج الوثائقي قد نلجأ فيه في كثير من الأحيان إلى ما يعرف بـ “الدوكودراما” بمعنى الفيلم “الوثائقي الدرامي”، حيث نلجأ إلى التمثيل لتجسيد بعض المشاهد، هناك مشاهد صُورت بعدما جهز المتحف بالكامل، ولكنها توحي بأنها مشاهد تسبق عملية الشروع بالبناء، بالتالي فإن الأفلام الوثائقية هي تجسيد وحفظ لأحداث حقيقية بالكامل، أو إعادة مسرحتها وتجسيدها.
أنا بالأساس منتج لأعمال درامية، لذلك وظفت كل إمكانياتي في الإنتاج الدرامي لأتمكن من إخراج عمل وثائقي جيد، متفاديًا أي شعور بالملل للمتلقي فالمعلومات الجامدة قد تبعث بالملل؛ لذلك كان لا بد من سرد المعلومات بطريقة قصصية درامية ولكنها معلوماتية بنفس الوقت.
ما تم ذكره في فيلم “الأساس الخالد” أنه من إخراجكم، ماذا عن تأليف أو إعداد النص؟
– نص المادة كذلك من إعدادي كما ذكرت، وتنوع الفيلم في فقراته، لنتنقل من الإلقاء –وهو بصوت الإعلامي خالد السلامي- ثم اللقاءات، وبعد ذلك مشاهد مرتبطة بالموسيقى، والمشاهد الجرافيكية، وهكذا كانت المشاهد متنوعة لم تخل من الجانب التقني والجرافيكي المرئي.
بالعودة إلى الأعمال السابقة، لديك تجارب في التأليف المسرحي والدرامي، دعنا نرجع إلى الماضي القريب ونتحدث عن مسرحية “ولد البلد”، وهو عمل من تأليفك وإخراجك، العمل ليس كوميديا فحسب، بل فيه إسقاطات على كثير من الموضوعات، ما الذي أردت أن توصله للناس؟
– يصعب عليّ حقيقة أن أغلق فكرة العمل المسرحي بإجابة صريحة توقف حتى اجتهاد المتلقي في تفسير وتحليل ما رآه في العمل، ما يبعث في نفسي الفرح أنني لمست من الكثير تفسيرات متعددة وتأويلات مختلفة، وكل تأويل يناسب الهم الشخصي لصاحبه، أي أنه يسقط ما رآه في نفسه، هنا يشعر المتلقي بأن قضيته وهمه قد تم ذكرهما، ووجد من تكلم نيابة عنه، وكنت أحاول في هذا الجانب أن تلتقي أطياف مختلفة، من أراد أن يسمع صوتا مغايرا، من أراد أن يأتي للضحك فقط، من أراد أن يشاهد أداء مسرحيا، وقد التقيت بأشخاص عدة ممن حضروا العرض، وكان لكل واحد منهم تأويل مختلف جزئيا عن الآخر، لذلك لا أريد أن أقدم إجابة مباشرة وأُغلق باب هذه التأويلات، أذكر أنه من بين الحضور معلمٌ من المملكة الأردنية صعد إلى خشبة المسرح لتحية فريق العمل وقال لمساعد المخرج بدر النبهاني: (ما أدراك بكثير من المواقف الاجتماعية في بلادنا الأردن!)، رغم أن هذا المعلم من بلد بعيد عن بلدنا إلا أنه أسقط ما رآه على مجتمعه، كذلك كان حاضرا الأديب البحريني قاسم حداد، وقال لي بأن الحال مشترك، وهنا تكمن أهمية النص المفتوح حيث يلامس نطاقًا واسعًا من الجمهور.
هل لجأت إلى “التغريب” في “ولد البلد” لهذا السبب، لسبب التعميم وعدم إغلاق النص على المجتمع المحلي؟ في حين يلجأ البعض إلى “التغريب” في محاولة لتبرئة نفسه من الإسقاطات على المجتمع المحلي؟
– يمكن القول بأن الجزء الآخر من السؤال صحيح، عندما كان “الرقيب” يضغط على بعض الأعمال، كنا نلجأ إلى “التغريب” لتمرير نص قابل لتأويلات عدة، التغريب الذي أعني به تذكير المشاهد بأن ما يقدم الآن هو عرض مسرحي لا أكثر، وهذا قد خدمني ولم يضرني.
ما هي دوافعك لكتاب نص مسرحي أو درامي؟
– بالنسبة لي لا أعرف متى أكتب نصا مسرحيا، وليست لي خطة لذلك، هناك دوافع متعلقة بالهم الشخصي، أو ألم محدد، هو ما يحرك في نفسي الكتابة المسرحية، ومن هذه المشاعر يولد نص مسرحي، أنا ألجأ إلى السخرية وليس “الكوميديا” في محاولة لتجاوز الألم، ليصبح الألم مضحكا، لذلك أجد أنني قدمت عملا يطلق عليه “كوميديا” رغم تحفظي على هذا التصنيف، حتى أن مسرحية “ولد البلد” كنت رافضا أن يكتب عليها “كوميدي”، لا بد أن أذكر أن كلمة “مسرحية كوميدية” هي كلمة صحيحة، وشكل من أشكال المسرح بكل تأكيد، ولكن للأسف استخدمت بعد ذلك بطريقة مبتذلة.
أشيع أن “ولد البلد” كانت بمثابة تحدٍ لمالك المسلماني، وأنه خسر التحدي “ماليًا” على الأقل، أي تكبدت خسارة مالية نظير عدم الإقبال على مسرحٍ يعد مكلفا –أعني مسرح مدينة العرفان- خاصة في اليومين الأخيرين، كيف ترد على ذلك؟
– دعني هنا أقسم الحديث إلى شقين، إيجابي وسلبي، وأبدأ بالشق الإيجابي، كانت تجربة “ولد البلد” إيجابية، فقد خدمتنا هذه التجربة، خدمت جميع من عمل، عرفتنا على بعضنا أكثر، بالواقع هناك مسافة عجيبة في الدراما العمانية، وأظن أن هذه المسافة من أسباب عدم ثبات المستوى، المشهد الثقافي بعيد عن الوسط الفني رغم أنه بالأساس وسط واحد، ولكن كل واحد منهم بجهة، والعملية الفنية تُدار من قبل الشباب التقنيين، ولكن الفنان وحده والمثقف وحده والتقني وحده لا يمكنهم –كل على حدة- إنتاج عمل فني جيد، لذلك تجربة ولد البلد أعادت هذا التلاحم وهذا التعاون، إذا لم يكن في إعداد المسرحية تكفي المشاركة بالحضور وإبداء الانطباع والنقد الموضوعي، ربما من أواخر هذا التعاون كان في عام 2010 في إنتاج العمل الكرتوني “يوم بيوم” الذي اشترك في إنتاجه عدد من المثقفين والفنانين واشتركوا كذلك في ورش إعداد النص، “يوم بيوم” جمع حوالي 25 كاتبا مثقفا.
في الثمانينات كان هذا التلاحم –بين الوسط الثقافي والفني- حاضرا، فأُنتجت أعمال جميلة مثل مسرحية “دختر شال سمك” في عام 1988 التي اشتهرت خليجيا، وهي مسرحية بالأساس مقتبسة من مسرحية “طبيب رغم أنفه” للكاتب الفرنسي “مولير”، وتم تعمينها من قبل الدكتور عبدالكريم جواد واشتغل معه مجموعة من المثقفين، ومسرحية “ولد البلد” أعادت –بوجهة نظري- هذا التلاحم.
وهناك مكاسب عديدة من أكبرها – وتهون أمامها أي خسائر مادية – إعادة الثقة في عدد من الفنانين الكبار الذين لم يصعدوا على خشبة المسرح بصفتهم ممثلين منذ سنوات طويلة، يحدثني الفنان صالح زعل قائلا: (مر زمن لم أشعر بهذا الحب من الجمهور)، وفي المقابل أيضا للجمهور فرصة لمشاهدة هؤلاء النجوم أمامهم وتحيتهم والتفاعل معهم، بعدما كان يشاهدهم لفترة طويلة عبر الشاشات من خلال الدراما التي تثير الجدل في كثير من الأحيان.
ومكاسب كثيرة حقيقة منها التلاحم بين الأجيال الفنية، ليس تلاحما في وقت العرض فقط، بل طيلة أيام التدريبات، وبعد ذلك، كانت هناك فجوة بين الأجيال الفنية، كل جيل منغلق على نفسه ويعتقد بأن الجيل الآخر لا يتقبل الاندماج معه في عمل، وهذه النظرة التي لا تخرج من إطار الظن انعدمت في مسرحية ولد البلد، فالجميع كان مرحبا بالآخر واشتغل معه بأُلفة وحب.
والشق السلبي، تمثل فقط في الخسائر المادية المتمثلة في سداد مستحقات المسرح، ولكني هنا أشيد بالتفهم الكبير من قبل إدارة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تم التوصل إلى اتفاق، فنحن بوصفنا شركة إنتاج “أكاسيا” نعمل في الإنتاج الفني، أُسندت مشروعاتهم الدعائية والتسويقية والفنية إلينا مقابل أن يكون ذلك في سبيل تسديد المستحقات، وحقيقة هناك كرم كبير من إدارة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض إذ نجد في المنشورات العلامة التجارية لشركة “أكاسيا” وهذه دعاية مجانية لنا، والأهم هو التفهم الحقيقي الذي لمسناه وتمنياتهم الصادقة بمواصلة العمل المشترك.
وقبل فترة من الآن تواصل معنا مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بغية تقديم عمل مسرحي جديد على مسرح مدينة العرفان، بهدف تكرار التجربة.
الإنفاق على العمل كان كبيرا، ولكن هذه الأمور تحدث في الكثير من المسرحيات، وهذا سيناريو متكرر.
“توين فيلا”، و “بنك الحارة”، عملان كوميديان من تأليفك، مر عليهما أكثر 10 سنوات، هل هناك جديد يطبخ على نار هادئة؟
– لنوضح أولا أن مسلسل “توين فيلا” كنت فيه كاتبا مشاركا مع الكاتبة أمل السابعي وهي لها الحصة الأكبر من الكتابة، بينما مسلسل “بنك الحارة” كتبته بنفسي، ولكن قبل أن أكتبه قمت بدعوة مجموعة من الكتاب لعمل ما يشبه بالورشة الكتابية، وكانت بداية الفكرة أن نقوم فعلا بكتابة الحلقات من خلال الورشة ولكن لم أستطع إقناع الكتّاب بالورشة فقمت بكتابة الحلقات بنفسي.
وبالحديث عن القادم هناك فعلا نص درامي كتبته بعد “بنك الحارة”، وهو مشابه بشكله فقط لـ بنك الحارة (سيت كوم)، إذ تدور كافة الأحداث في مدرسة وفي بيئة محاكية لعام 1986 وطلاب جميعهم في الصف الثالث الإعدادي، آخر صف بالمدرسة، فكرة العمل تمزج بين الحديث والقديم، إذ تلتقي مجموعة من الأشخاص في الوقت الحالي، مختلفون في اختصاصاتهم ومناصبهم وأعمالهم، وتجمعهم زمالة الدراسة الإعدادية، فتكون المشاهد في المدرسة عبارة عن تصوير الذكريات “فلاش باك”، والعمل يوثق لكثير من الأحداث التي وقعت في عام 1986، ومن ضمن الجهود التي بذلتها للتوثق من النص أن قدمته لمختصين من وزارة التربية والتعليم بشكل ودي للنظر ما إذا كان هناك مسّ بمكانة المعلم، إلا أن الرد جاء لصالح النص.
آمل في القريب العاجل أن يظهر هذا العمل للنور، وهناك عمل قيد الاشتغال والبناء في المراحل الأول، ولكن لم يحن الأوان للحديث عنه.
لماذا ابتعدت عن التمثيل، رغم ما لديك من تجارب؟
– في مسلسل “بنك الحارة” شاركت في التمثيل بدور مدير البنك، حقيقة أنا أكتب النصوص، ولكني غالبًا لا أجد نفسي وشخصيتي في أغلب النصوص، وليس من باب الميل إلى الكتابة والإخراج على حساب التمثيل، بل أنا أحب التمثيل كثيرا، ولكن إن لم أجد نفسي في عمل ما كممثل فلا أقحم نفسي، أرى أن جودة العمل أهم وأولى من المشاركة بدور لا يلائمني، أو دور قد يكون إضافة مخلة أو مربكة في العمل، في مسرحية “ولد البلد” كنت متلهفًا بشكل كبير أن أشارك فيها ممثلا، وحاولت جاهدا أن أجد لي دورا يشكل إضافة في العمل وحاولت بعد إتمام النص أن أختار دوري، ولكني لم أجد ذلك الدور، حتى أنني حاولت أن أكون من ضمن المجاميع –وهم أبطال في العمل- ولكن في آخر لحظة توليت زمام التحكم الصوتي وذَهَبت مني فرصة المشاركة مع المجاميع، صحيح أن المجاميع قد ارتدوا أقنعة وأنني لو ظهرت معهم لن يعرفني الجمهور، ولكن كان يكفيني ذلك.
في سياق الحديث، ذكرت أن هناك عملا لم يحن الأوان للحديث عنه، ولكن على الأقل ما هي ملامح هذا العمل وطبيعته؟
– أنا أخطط أن أقتحم هذا العالم السحري، عالم السينما، ومن المحتمل أن أدخله من أبواب عدة ، كاتب وممثل، وحقيقة هو أول نص أكتبه لعمل سينمائي، دخول هذا العالم مخيف بالنسبة لي، هو مجال يحتاج إلى استعداد حقيقي واشتغال جيد، العمل السينمائي القصير يتطلب التكثيف، وكل لقطة فيه لا بد وأن تكون ذات دلالة.