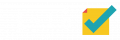آمنة الربيع
إما مسافة واحدة أضعها بين اللحظة التي تخلفت فيها عن متابعة قراءة المصادر الرئيسة في المسرح التي كنت أحرص عليها عادةً سنويةً، أو أجدد اللقاء والعودة متخيلة وجود مستند فارغ يحتاج إلى التعبئة الدقيقة بالخسارات التي حصلت عليها بعدما تخلفت عن عادتي القديمة!
في كتاب الذوق الأدبي كيف يتكون؟ لأرنولد بينيت، ترجمة دلال الرمضان، الصادرة طبعته الأولى في سبتمبر عام 2018م بالتعاون بين داري نشر الرافدين ومنشورات تكوين هناك سؤال يثار اليوم حول قيمة الأدب في نظام زمن التفاهة، ففي ظل منصات التواصل الافتراضي المنتشرة اليوم وما تبثه من أفلام ومسلسلات وحفلات وبرامج بها الغث والسمين، وفي غياب الحلقات النقاشية الثقافية النقدية الوازنة التي تناقش بموضوعية واتزان مختلف البنى السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية، ومع تراجع الدور التنويري للنخب المثقفة والإعلام والصحف المحلية في مجتمعات الوطن العربي كلها، هل ثمة تقدير للأدب الكلاسيكي وللنقد؟
إن كتاب الذوق الأدبي كيف يتكون لا يهتم بإجابة تلك الأسئلة وما تثيره من مخاوف لدينا، إنما يهتم في المقام الأول أن يدلنا على الطريق الصحيح لتكوين الذوق الأدبي، ولأن الكتاب هدفه تعليميٌّ لذلك يتضمن «توجيهات وإرشادات مفصّلة لجمع مكتبة أدب إنجليزي متكاملة»، وقياسا عليه يمكن للقارئ العربي تأسيس مكتبة تقابلها بأهم كتب المصادر والمراجع العربية في أدب المسرح.
يتألف الكتاب من أربعة عشر فصلا كالآتي: «الهدف، وحالتك الخاصة، ولماذا سميت الكلاسيكيات بهذا الاسم؟ ومن أين تبدأ؟ وكيف تقرأ عملا كلاسيكيا، ومسألة الأسلوب، وصراع مع مؤلف، وطريقة للقراءة، والشعر، ونصائح متنوعة، ومكتبة للغة الإنجليزية لثلاثة مراحل، وأخيرا التقييم الذهني».
تبدو الفصول جميعها مهمة عندما يُمعن الباحث في تأملها، والنظر فيها بترو كبير. لكن الدوافع الخاصة التي قادتني إلى تناول هذا الكتاب بَدت غير متجانسة فيما بينها، فبحكم حرصي السنوي القديم الذي تبدد في السنوات الأخيرة حول قراءة أهم المصادر التأسيسية للمسرح ونظرياته واتجاهاته ومدارسه، أخذتُ في السنوات الخمس الأخيرة أقلل من هذه العادة مبتعدة إلى قراءة النتاج المعاصر، والأسباب التي يُمكنني تقديمها أعذارًا لا أظنني سأقبلها، لكنها صارت، ولذا عندما وقعت عيناي على عنوان هذا الكتاب من ضمن كتب مهملة في مكتبتي تناولته بيسر وسألت نفسي: ما الذي يدفعني إلى قراءته؟ وهل أنا في حاجة حقيقية له؟ هل هناك شيء من الشعور بالذنب يَسكنني؟
في بادئ الأمر ثمة مفهوم ثقيل يجري التعامل به لتقييم الذات بعد هذا العمر! ففي مرحلة كنت أظن أنه كان يجب عليَّ الانتهاء من قراءة جميع الكتب التي اقتنيتها من معارض الكتب المختلفة، ومع انشغالات الدراسة والخبرات صار الحرص على قراءة بعض الكتب المهمة في التخصص هي الهدف الأساسي، ومع تقدم الزمن تعلمتُ شيئا مهمًا؛ عليَّ أن أضع نصب قلبي قراءة ما سوف يساعدني على الاستمتاع بالحياة والأدب فقط، لهذا، وبعد قراءة فصول الكتاب وجدتني تلقائيا أعود إلى القراءة الثانية للكوميديا الإلهية لدانتي، فأنا أظنه يستحق القراءة، لاسيما، إذا قرأتها بالتزامن مع النصوص العربية التي تأثر بها دانتي.
الفصل المهم الذي استوقفني في الكتاب: «لماذا سميت الكلاسيكيات بهذا الاسم؟» إن زمن الكلاسيكيات قد ولى وانتهى، ولكن هل لدينا اليوم من الهُواة الذين يذهبون إلى المسرح مَن يقرأها؟ هل هناك مَن يعرفُ أنتيغون وصراعها الأخلاقي المحض مع الطاغية كريون؟ لكن، ربما يسأل سائل: أَمِنَ الضروري أن كلّ من أراد الدخول إلى المسرح عليه أن يعرف مآسي المسرح الإغريقي كلها؟ ما الذي سيضاف إلى القارئ الشاب أو القارئة الشابة من معرفة ثمينة إذا كانت أنتيغون مذنبة أم بريئة في تحديها لسلطة النظام والأحكام وقوانين المدينة الصارمة؟ وما الذي سيجنيه الهُواة مِن موقف هاملت تجاه أوفيليا، أو نحو أمه غرترود؟
صُدمتُ في الملتقى الأدبي عام 2015م عندما شاركتُ ضمن لجنة تحكيم للنصوص المسرحية من شاب دارس للتمثيل لكنه يَجهل سوفوكل، بينما قالت ممثلة أخرى إنها لم تَسمع به من قبل! كذلك في إحدى الورش التدريبية حول الكتابة الإبداعية للمسرح استوقفني سؤال أحد المتدربين الدراسين للمسرح أربع سنوات جامعية حينما قال إنه لم يفهم مسرحية في انتظار غودو!
إن أرنولد بينيت (1867-1931) الكاتب المسرحي والناقد الأدبي الإنجليزي المعروف منطلقا من «استمرار الشهرة الواسعة لكتّاب الكلاسيكيات» قاعدةً واسعةَ النطاق يُقدم إجابة بسيطة لكنها عميقة وحقيقية وصادقة؛ فتسميتها بالكلاسيكيات لأنها أعمال تُقدم «المتعة لقلة من القراء الذين يهتمون بالأدب بشكل مكثف ودائم، وهذا العمل يحيا بسبب تلك القلة التي تسعى دائما لتجديد ذلك الشعور بالمتعة».
يؤكد أرنولد أيضا على أهمية تلك القلة أو ما نسميهم اليوم بالشِّلة الذين يلتفون حول الأدب عمومًا، والأدب المسرحي على وجه الخصوص، فهؤلاء وجدوا في مآسي التراجيديات اليونانية «حماسة دائمة وقوية تجعلهم يستمتعون بها … كما أن تواتر وتكرار هذه المتعة يُبقي اهتمامهم بالأدب حيّا.» إن بقاءنا أحياء بسبب الأدب أمر له وجاهته. أليس كذلك؟ وعلى الرُّغم من هذا الاستنتاج، إلا أن أرنولد يُبقيه قيد التشكك، فلا أحد منّا على وجه الحقيقة يعلم لماذا لا يُعجبه شقاء الملك أوديب، ولا يروق له موقف ميديا- المرأة الأكثر خسة في المسرح الإغريقي- تجاه طفليها، لكن من المؤكد أن سلوك دفاع أنتيغون عن دفن أخيها وفقا للتقاليد والقواعد التي تليق بدفنه دون ترك جثته ملقاة في الصحراء تنهشها الطيور والضواري لموقف مشرَّف. وينبع ذلك من تأكيد الأدب عبر موقف أنتيغون على قيم النبل والحق والواجب والعدالة، وهي قيم ينتصرُ لها الأدب في كل مكان، فلا ينبغي التضحية بها لمجرد أن الباطل والجهل والظلم والفساد غدت الأكثر انتشارًا.
يقول عبدالرحمن بدوي في ترجمته لأنتيغون نقلا عن باتان Patin: «لا يوجد في أية مسرحية يونانية أخرى مثل هذا السمو في الأفكار، ومثل هذه العظمة في العواطف، ومثل هذا التصوير النبيل للإنسانية؛ وبهذا كله فإن هذه المأساة – تقترب أكثر من غيرها- من الهدف الذي سعى إلى بلوغه فن المأساة، والذي نحوه توخّت انفعالات الرحمة والخوف بوصفها معابر ودرجات، أعني الوصف المثالي لطبيعتنا».
إنني أعرف شخصيا لماذا تُمتعني أنتيغون وتروقني، فإلى جانب الأسباب السابقة سأضيف إليها هذه السطور التي لا أخفي إعجابي بها ترد على لسان أنتيغون في حوار لها مع أختها إسمينا أمام القصر الملكي في ثيبا، والحوار يكشف عن أكثر من وظيفة؛ اجتماعية، وتاريخية، وثقافية ودرامية: «أنتِ دَمِي، وأختي، يا إسمينا، يا عزيزتي. وأنتِ تعرفين كل المصائب التي خلّفها أوديب لأهله. لكن تعرفين واحدة منها لم يحرص زيوس على أن يبلغ بها أوج الشدّة إبّان حياتنا نحن هنا».
إن موقف أنتيغون الذي خلّده الأدب المسرحي إنما يعود إلى مثابرة تلك القلة وإصرارها على عدم ترك أنتيغون وحيدة تصارع النظام الاستبدادي، لذلك يستمر القراء المخلصون للأدب المسرحي في العالم كله، على تنمية التذوق الفني وتدريب الأجيال لملء المستند الفارغ بما يليق به من مصادر ومراجع كلاسيكية أو حديثة، وبفضل هذه القلة كما يقول أرنولد بينيت: « يُحافظُ على استمرار شهرة الكاتب ونقلها من جيل لآخر».
https://www.omandaily.om/ثقافة/na/مسافة-واحدة-أو-مستند-فارغ